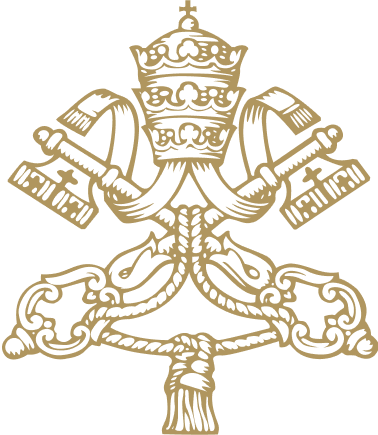كلمة قداسة البابا فرنسيس
إلى مؤمني أبرشيّة روما
يوم السبت 18 أيلول/سبتمبر 2021
قاعة بولس السادس
________________________________________
أيّها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير!
كما تعلمون – هذا ليس شيئا جديدا! –، إنّ مسيرة سينوديّة على وشك أن تبدأ، مسيرة تلتزم فيها الكنيسة بكاملها بهذا الموضوع: "من أجل كنيسة سينوديّة: شركة ومشاركة ورسالة": ثلاث ركائز، وثلاث مراحل، ستقام من تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 وحتى تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. وقد تم تصوّر هذا المسار على أنّه دينامية إصغاء متبادل، وأود أن أؤكد على هذا: دينامية إصغاء متبادل، تتم على جميع مستويات الكنيسة، بمشاركة جميع شعب الله. يجب على الكاردينال النائب العام والأساقفة المساعدين الإصغاء بعضهم إلى بعض، ويجب على الكهنة الإصغاء بعضهم إلى بعض، والرهبان يصغون بعضهم إلى بعض، والعلمانيون يصغون بعضهم إلى بعض. ثم الجميع يصغون بعضهم إلى بعض. إصغاء. وكلام وإصغاء متبادل. ليس الأمر جمعَ آراء، لا. هذا ليس تحقيقًا، بل هو إصغاء إلى الروح القدس، وكما يقول في سفر الرؤيا: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ (2، 7). لنا آذان، ونصغي. هذا هو الالتزام الأوّل. يجب سماع صوت الله، وقبولُ حضوره، وإيقافه عند مروره وعند نفخة الحياة منه. حدث للنبي إيليا أنّه اكتشف أنّ الله هو دائما إله المفاجآت، حتى في الطريقة التي يمُرُّ بها ويظهر بها.
"فإِذا الرَّبُّ عابِرٌ وريحٌ عَظيمةٌ وشَديدةٌ تُصَدِّغ الجِبالَ وتُحَطِّمُ الصُّخورَ […] ولم يَكُنَ الرَّبُّ في الزِّلْزال. وبَعدَ الزِّلْزالِ نار، ولم يَكنِ الرَّب في النار. وبَعدَ النَّارِ صَوِت نَسيمٍ لَطيف فلَمَّا سَمِعَ إِيليَّا، سَترَ وَجهَه بِرِدائِه" (1 ملوك 19، 11-13).
هكذا يكلِّمُنا الله. ومن أجل هذا ”النسيم اللطيف“ – الذي يترجمه المفسرون أيضًا ب”صوت الصمت الخفيف“ وآخرون ب”خيط صمت منغَّم“ - يجب أن نجعل آذاننا جاهزة، لنسمع نسيم الله هذا.
المرحلة الأولى من المسيرة (تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 – نيسان/أبريل 2022) تخص الكنائس الأبرشيّة، كلّ واحدة بمفردها. ولهذا السبب أنا هنا، لأني أسقفكم، للمشاركة معكم، لأنّه من المهم جدًا أن تلتزم أبرشية روما عن قناعة في هذه المسيرة. إن لم تشارك أبرشيّة البابا جدّيًّا فيها، قد يعطي انطباعًا سيئًا، أليس كذلك؟ انطباعًا سيئًا عن البابا وأيضًا عنكم.
موضوع السينوديّة ليس فصلًا يُكتَب في مؤلَّفٍ في عِلم الكنيسة، وبالتأكيد ليس موضة أو شعارًا أو مصطلحًا جديدًا يتم استخدامه أو الاستفادة منه في اجتماعاتنا. لا! تعبّر السينوديّة عن طبيعة الكنيسة وصورتها ونَهجها ورسالتها. لهذا نتكلم على الكنيسة السينوديّة، لكن نتجنّب اعتبارها عنوانًا من بين عناوين أخرى، وطريقة في التفكير بين طرق بديلة أخرى. أنا لا أقول هذا على أنّه رأي لاهوتي، ولا فكرةً شخصية، ولكن لأنّه اتِّباع لما يمكن أن نعتبره "الدليل" لعِلم الكنيسة الأوّل والأهّم، وهو سفر أعمال الرسل.
تحتوي كلمة ”سينودس“ على كلّ ما نحتاج إلى فهم العبارة: ”السير معًا“. سفر أعمال الرسل هو قصة مسيرة تبدأ من أورشليم، وتمر بالسامرة واليهودية، وتستمر في أراضي سوريا وآسيا الصغرى ثم في اليونان، وتنتهي في روما. تروي هذه الطريق القصة التي تسير فيها كلمة الله والأشخاص الذين وجَّهوا انتباههم وإيمانهم إليها. كلمة الله تسير معنا. وكلّنا شخصيات رئيسية، لا يمكن أن نعتبر أحدًا شخصية ثانوية. يجب أن نفهم ذلك جيدًا: كلّنا شخصيات رئيسية. ليس البابا، والكاردينال النائب العام، والأساقفة المساعدون شخصيات أكبر من غيرهم. لا: نحن جميعًا شخصيات رئيسيّة، ولا يمكن اعتبار أيّ واحد شخصيّة ثانوية أو مضافة. الخدمات في ذلك الزمن كانت لا تزال خدمات حقيقيّة. والسّلطة كانت تنشأ من الإصغاء إلى صوت الله والناس – غيرَ منفصِلَيْن، أبدًا – والسّلطة كانت تبقي على ”المستوى الأدنى“، مستوى الذين يقبلونها. ”أدنى“ مستويات الحياة، التي كان من الضروري تقديم خدمة المحبّة والإيمان لها. ولكن هذه القصة لا تتحرك فقط في الأماكن الجغرافية التي تجتازها. إنّها تعبّر عن قلق داخلي مستمر: هذه كلمة رئيسية، القلق الداخلي. إذا كان المسيحي لا يشعر بهذا القلق الداخلي، إذا لم يَعِشْه، ينقصه شيء ما. وهذا القلق الداخلي يولد من الإيمان الشخصي ويدعونا إلى تقييم ما هو الأفضل لنعمله، وما يجب الحفاظ عليه أو تغييره. تُعلِّمنا هذه القصة أنّ التوقف عن الحركة لا يمكن أن يكون حالة جيدة للكنيسة (راجع فرح الإنجيل، 23). الحركة هي نتيجة الطاعة للروح القدس، هو المُخرِج لهذه القصة، حيث الكل شخصيات رئيسية قلقة، ولا يتوقفون أبدًا.
بطرس وبولس، ليسا مجرد شخصَيْن لهما طباعهما الخاصة، بل هما رؤى منزرعة في آفاق أكبر منهما، وهما قادران على إعادة التفكير في كلّ ما يحدث، وهما شاهدان لاندفاع يضعهما في أزمة - تعبير آخر يجب أن نتذكره دائما: مواجهة الأزمة – ويحملهما على الجرأة والسؤال وإعادة التفكير وارتكاب الأخطاء والتعلّم منها، وقبل كلّ شيء على الرّجاء بالرغم من الصعوبات. إنّهما تلميذَا الرّوح القدس الذي جعلهما يكتشفان جغرافية الخلاص الإلهي، فاتحًا أمامهما الأبواب والنوافذ، وحطَّم الجدران، وكسَّر السلاسل، وحرّرهما من الحدود. أمام هذا، من الضروري أن نغادر ونغيّر المسار، ونتغلَّبَ على قناعات تقيِّدنا وتمنعنا من التحرك والسير معًا.
يمكننا أن نرى الروح يدفع بطرس ليذهب إلى بيت كرنيليوس، قائد المائة الوثني، على الرغم من تردده. تذكروا: رأى بطرس رؤيا أزعجته، حيث طُلب منه أن يأكل أشياءً تُعتبر نجسة، وعلى الرغم من تطمين الله له بأنّ ما يطهِّره الله يجب ألّا يُعتبر نجسًا بعد الآن، إلّا أنّه ظلّ حائرًا. كان يحاول أن يفهم، إذّاك أتى الرجال الذين أرسلهم كرنيليوس. وقد رأى هو أيضًا رؤية ورسالة. كان ضابطًا رومانيًّا تقيًّا، متعاطفًا مع اليهودية، لكنّه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية حتى يكون يهوديًّا أو مسيحيًّا كاملًا: لم يكن في حالة تسمح له أيّة حدود دينيّة بالدخول. كان وثنيًّا، ومع ذلك، أوحيّ إليه أنّ صلواته قد وصلت إلى الله، وأنّه يجب أن يرسل شخصًا ليخبر بطرس ليأتي إلى بيته. في هذه الحالة المحيِّرة، من جهة، بطرس وشكوكه، ومن جهة أخرى كرنيليوس الذي ينتظر في الظل، هو الرّوح الذي وضع حدًّا لمقاومة بطرس وفتح صفحة جديدة في الرسالة. هكذا يتحرّك الرّوح. هكذا. واللقاء بين الاثنين يُختَتم بإحدى أجمل العبارات المسيحيّة. ذهب كرنيليوس لمقابلة بطرس، وألقى بنفسه عند قدميه، لكن بطرس أقامه وقال له: "قُمْ، أَنَا أَيْضًا إِنْسَان" (أعمال الرسل 10، 26)، وكلّنا نقول هذا: ”أنا رجل، أنا امرأة، نحن بشر“، وعلينا جميعًا أن نقول ذلك، حتى الأساقفة، كلّنا: "قُمْ، أَنَا أَيْضًا إِنْسَان". ويؤكّد النص أنّه تحدّث معه بطريقة ودِّية (راجع الآية 27). يجب أن تكون المسيحيّة دائمًا إنسانيّة، ومثبِّتة للإنسانيّة، وتُصالِح بين الاختلافات وتُقلِّص المسافات، وتحوّلها إلى ألفة وقرب. أحد مساوئ الكنيسة، بل إفساد لها، هو ”روح التسلط الإكليريكي“ الذي يفصل الكاهن والأسقف عن الشعب. الأسقف أو الكاهن المنفصل عن الشعب هو موظف، وليس راعيًا. كان البابا القديس بولس السادس يحب اقتباس مقولة للكاتب اللاتيني تيرنسيوس (Terentius) وهي: "أنا إنسان، ولا شيء من الإنسان غريب عني". اللقاء بين بطرس وكرنيليوس وجد حلًّا لمشكلة، وشجع على اتخاذ القرار بالشعور بالحرّيّة في تبشير الوثنيين مباشرة، مع القناعة - هذه هي كلمات بطرس - أنّ "اللهَ لا يُراعي ظاهِرَ النَّاس" (أعمال الرسل 10، 34). باسم الله لا يمكن أن نفرِّق. والتفرقة خطيئة بيننا أيضًا (كأنّنا نقول): ”نحن أنقياء، نحن مختارون، نحن من هذه الحركة التي تعرف كلّ شيء، نحن...“. لا. نحن كنيسة، كلّنا معًا.
كما ترون، لا يمكنّنا فهم ”الكاثوليكيّة“ دون الرجوع إلى هذا المجال الواسع المضياف، الذي لا يرسم حدودًا على الإطلاق. أن نكون كنيسة هو طريق للدخول في رحابة الله هذه. ونعود إلى أعمال الرسل، نشأت مشاكل تختص بتنظيم العدد المتزايد من المسيحيين، ولا سيما تلبية احتياجات الفقراء. أشار البعض أنّه تم إهمال الأرامل. والطريقة التي سيتوصلون بها إلى الحل هي استدعاء جماعة التلاميذ، ليتخذوا معًا قرار تعيين هؤلاء الرجال السبعة الذين سيعملون طوال الوقت في الدياكونيا (الخدمة)، في خدمة المائدة (أعمال الرسل 6، 1-7). وهكذا، مع التمييز للمواهب، ومع الاحتياجات، ومع واقع الحياة وقوّة الرّوح، تمضي الكنيسة قدمًا، وتسير معًا، إنّها سينوديّة. ولكن الرّوح القدس هو دائمًا الشخصيّة الأولى الرئيسية في الكنيسة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا المقارنة بين الرؤى والتوقعات المختلفة. ويجب ألّا نخشى أن يحدث هذا اليوم أيضًا. بل أتمنى أن يتم الناقش هكذا! إنّها علامات على الانفتاح والطاعة للرّوح. ويمكن أن تحدث أيضًا خلافات تحتّد وتصل إلى ذروتها، كما حدث في مواجهة مشكلة ختان الوثنيين، إلى أن تمَّ التشاور في ما نسميه مجمع أورشليم، المجمع الأوّل. وكما يحدث اليوم، يوجد طريقة متصلبة للنظر في الظروف، التي تتحدّى صبر الله وطول أناته، أي الصّبر الذي يتغذى بالرؤى العميقة، والرؤى الواسعة، والرؤى الرّحبة: الله ينظر إلى بعيد، الله ليس في عجلة. التصلب في الرأي هو فساد آخر وهو خطيئة ضد صبر الله، إنّها خطيئة ضد سيادة الله. اليوم أيضًا يحدث هذا.
وما حدث بعد ذلك هو: أنَّ بعض الذين اهتدوا من اليهوديّة، حافظوا على مرجعيتهم الذاتيّة، بأنّه لا يمكن أن يكون هناك خلاص دون الخضوع لشريعة موسى. لكن هذه الطريقة كانت انتقادًا لبولس، الذي أعلن أنّ الخلاص يتم مباشرة باسم يسوع. والتصدي لعمله كان يؤثّر على قبول الوثنيين، الذين كانوا يهتدون في هذه الأثناء. أرسل الرسل والشيوخ بولس وبرنابا إلى أورشليم. ولم يكن الأمر سهلًا: ففي مواجهة هذه المشكلة بدت المواقف غير قابلة للتسوية، وقد تمّت مناقشتها باستفاضة. والقضية هي الاعتراف بحرّيّة عمل الله، وأنّه لا توجد عقبات يمكن أن تمنع من الوصول إلى قلوب الأشخاص، مهما كان أصلهم أو حالتهم الأخلاقيّة أو الدينيّة. وُجِد الحل بقبول كلام "الله عارف القلوب"، يعرف القلوب، هو نفسه يؤيد إمكانية قبول الوثنيين للخلاص، "فشَهِدَ لَهُمْ مُعْطِيًا لَهُمُ الرُّوحَ الْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَيْضًا" (أعمال الرسل 15، 8)، وهكذا أيضًا منح الوثنيين الرّوح القدس، مثلنا. وبهذه الطريقة تمَّ احترام جميع المشاعر، وخفَّت حدّة المبالغات. وتمّ الاستفادة من خبرة بطرس مع كورنيليوس: هكذا نجد في الوثيقة النهائية شهادة حضور الرّوح في مسيرة القرارات، والحكمة التي يقدر الرّوح دائمًا على إلهامها: "فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا أَلاَّ يُلْقى علَيكم مِنَ الأَعباءِ سِوى ما لا بُدَّ مِنُه"، إلّا ما هو ضروري (أعمال الرسل 15، 28). ”نحن“: في هذا السينودس نسير في طريق القدرة على القول "فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا"، لأنّكم ستكونون في حوار مستمر بعضكم مع بعض، بقوة عمل الرّوح القدس، وأيضًا في حوار مع الرّوح القدس. لا تنسَوا هذه الصيغة: "فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا أَلاَّ يُلْقى علَيكم مِنَ الأَعباءِ سِوى ما لا بُدَّ مِنُه": فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا. لذا عليكم أن تحاولوا التعبير عن أنفسكم، في هذا الطريق السينودي، في هذا المسار السينودي. إذا لم يوجد الرّوح القدس، سيكون برلمانًا أبرشيًا، وليس سينودس. نحن لا نقوم ببرلمان أبرشيّ، ولا نقوم بدراسة في هذا أو ذاك، لا: نحن في مسيرة إصغاء بعضنا إلى بعض وإصغاء إلى الرّوح القدس، ومناقشة، ومناقشة أيضًا مع الرّوح القدس: وهذه أيضًا طريقة صلاة.
”الروح القدس ونحن“. لكنَّا نواجه دائمًا تجربة العمل وحدنا، والتعبير عن عِلم كنسي بديل - يوجد العديد، من العلوم الكنسية البديلة- كما لو أنّ الرّبّ يسوع، بعد أن صعد إلى السماء، ترك فراغًا يجب مَلؤُه، ونحن نملَؤُه. لا، الرّبّ يسوع ترك لنا الرّوح! كلمات يسوع واضحة: "أَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ [...] لاَ أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى (يوحنا 14، 16. 18). لتنفيذ هذا الوعد بأنّ الكنيسة سرّ، كما ذُكر في نور الأمم 1: "ولمّا كانت الكنيسة هي في المسيح بمثابة السرّ، أيّ العلامة والأداة في الاتّحاد الصّميم بالله ووَحدة الجنس البشريّ برمتّه". في هذه العبارة، التي تضم شهادة مجمع أورشليم، تنديد بالذين يصرون على أخذ مكان الله، ويزعمون أنّهم نموذج الكنيسة على أساس قناعاتهم الثقافيّة والتاريخيّة، وإجبارها على حدود محصَّنة، و”حدود جمركية“ تتهم بالخطيئة، وروحانيات تجدِّف على مجانية عمل الله الشامل. عندما تكون الكنيسة شاهدة، قولًا وفعلًا، لمحبّة الله غير المشروطة، ولجوده المضياف، فإنّها تعبّر حقًا عن كاثوليكيتها. وتندفع بذلك، من الداخل والخارج، لعبور كلّ مكان وزمان. الاندفاع والقدرة يأتيان من الرّوح: "سَتَنَالُونَ قُوَّةً مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى الأَرْضِ" (أعمال الرسل 1، 8). قبول قوّة الرّوح القدس لنكون شهودًا: هذه هي طريقنا نحن الكنيسة، وسوف نكون كنيسة إذا سلكنا هذه الطريق.
الكنيسة السينوديّة تعني كنيسة سرّ، أداة وعلامة، لهذا الوعد - أي أنّ الرّوح القدس سيكون معنا - الذي يتجلى من خلال تنمية علاقة حميمة مع الرّوح ومع العالم الذي سيأتي. ستكون هناك دائمًا مناقشات، والحمد لله. ولكن الحلول يجب البحث عنها بإعطاء الكلمة لله ولأصواته في وسطنا، فنصلّي ونفتح أعيننا على كلّ ما يحيط بنا، ونعيش حياة أمينة للإنجيل، ونسأل الوحي بحسب مبدأ تفسير مبني على مفهوم الحَجّ الذي يعرف أن يحافظ على المسيرة التي بدأت في أعمال الرسل. وهذا أمر مهم: طريقة الفهم والتفسير. مبدأ التفسير المبني على مفهوم الحج، أي دائمًا في مسيرة. المسيرة التي بدأت بعد المجمع (الفاتيكاني الثاني)؟ لا. التي بدأت مع الرّسل الأوائل، وتستمر. عندما تتوقف الكنيسة، لا تبقى كنيسة، بل تصير جمعية تقويّة جميلة لكنها تقيِّد الرّوح القدس. مبدأ تأويل مبني على مفهوم الحج يعرف أن يحافظ على المسيرة التي بدأت في أعمال الرسل. وإلّا فالرّوح القدس يُعرَّض للإهانة. جوستاف مالر( Gustav Mahler) – لقد قلت هذا مرات عديدة– أكد أنّ الأمانة للتقليد لا يقوم بعبادة الرماد ولكن بالمحافظة على النار. وأنا أسألكم: ”قبل أن تبدأوا هذه المسيرة السينودية، إلى ماذا تميلون؟ إلى حفظ رماد الكنيسة، أي جمعيتكم، أو مجموعتكم، أم إلى حفظ النار؟ هل أنتم أكثر ميلًا لعبادة أشيائكم، التي تحيط بكم - أنا من رعية القديس بطرس، وأنا من رعية القديس بولس، وأنا من هذه الجمعية، وأنتم من الأخرى، أنا كاهن، وأنا أسقف - أم تشعرون بأنّكم مدعوون لحفظ نار الرّوح؟ كان جوستاف مالر ملحنًا عظيمًا، لكنّه أيضًا بارع في الحكمة بهذا التأمل. يؤكد الدستور العقائدي في الوحيّ الإلهيّ، "كلمة الله" (رقم 8)، مستشهدًا بالرسالة إلى العبرانيين أنّ: "اللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُق كَثِيرَةٍ" (عبرانيين 1، 1)، لم يتوقف عن التكلّم مع الكنيسة عروس ابنه. للقديس منصور دي ليرانس (San Vincenzo di Lérins) كلام سديد يقارن فيه بين الإنسان في نمُوِّه وبين التقليد المنتقل من جيل إلى جيل آخر، فيؤكّد أنّه لا يمكن الحفاظ على ”وديعة الإيمان“ دون أن تتقدَّم: "فيشتّد (الإيمان) مع السنين، وينمو مع الزمن، وينضج مع العمر". (التفسير الأوّل، 23، 9). هذا هو أسلوب مسيرتنا: الوقائع، إن لم تتحرك، فهي مثل الماء. إنّ الوقائع اللاهوتية مثل الماء: إذا لم تكن المياه جارية وكانت واقفة، أصبحت أوّل شيء يفسد. الكنيسة المتجمدة تبدأ بالفساد.
ترون كيف أنّ تقاليدنا هي مثل العجين المختمر، هي واقع في حالة تخمّر حيث يمكننا أن نرى النمو، وفي العجين نرى الشركة التي تتحقق بالحركة: السير معًا يحقق الشركة الحقيقيّة. مرة أخرى، يساعدنا سفر أعمال الرسل، ويُظهر لنا أنّ الشركة لا تمنع الاختلافات. هذه مفاجأة العنصرة، حيث اللغات المختلفة لم تكن عقبة: على الرغم من أنّهم كانوا غرباء بعضهم عن بعض، وبفضل عمل الرّوح كان "يَسمَعُهم كُلّ منَّا بِلُغَةِ بَلَدِه؟" (أعمال الرسل 2، 8). أن نشعر بأنّنا في البيت، مختلفين ولكن متضامنين في المسيرة. معذرةً على الإطالة، لكن السينودس أمر جاد، ولهذا سمحت لنفسي بالكلام...
وأعود مرة أخرى إلى المسيرة السينودية. إنّ المرحلة الأبرشية مهمة جدًا، لأنّها تضمن الإصغاء إلى جميع المعمَّدين، هم موضوع ”حس الإيمان“ الذي لا يخطأ عندما نؤمن. توجد مقاومات كثيرة أمام إرادة التغلب على صورة كنيسة تميّز بشكل صارم بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين الذين يعلِّمون والذين يجب أن يتعلّموا، وينسون أنّ الله يحب أن يعكس الأدوار: قالت مريم العذراء "حطَّ الأَقوِياءَ عن العُروش ورفَعَ الوضعاء" (لوقا 1، 52). إنَّ السير معًا يكشف الخط الأفقي، بدل العمودي. الكنيسة السينودية تُعيد الأفق الذي تشرق منه شمس المسيح: رَفعُ الأبنية الهرمية يعني تغطيتها. الرعاة يسيرون مع الشعب: نحن الرعاة نسير مع الشعب، أحيانًا أمامهم، وأحيانًا في وسطهم، وأحيانًا خلفهم. على الراعي الصالح أن يتحرّك على هذا النحو: في المقدمة ليقود، وفي الوسط ليشجع وكي لا ينسى رائحة القطيع، وفي الخلف، لأن الشعب أيضًا له ”حس“ ويعرف كيف يسير. لديه حس لإيجاد طرق جديدة للسير، أو للعودة عن الطريق الضالّ. أريد أن أؤكد على هذا، وأيضًا لأساقفة وكهنة الأبرشيّة. في مسيرتنا السينوديّة لنسأل أنفسنا: ”لكن هل أنا قادر على السير، أو التحرّك، في الأمام وفي الوسط والخلف، أم أنّني فقط أجلس على الكرسي وألبس التاج وأحمل العصا؟“. رعاة مندمجون مع القطيع، لكن رعاة، وليسوا القطيع: القطيع يعرف أنّنا رعاة، والقطيع يعرف الفرق. في المقدمة لإظهار الطريق، وفي الوسط للشعور بما يشعر به الناس وخلفهم لمساعدة الذين لا يزالون وراء قليلًا والسماح للناس بأن يروا بحسهم أين هي أفضل الأعشاب.
يؤهل حس الإيمان الجميع لكرامة الخدمة النبويّة ليسوع المسيح (راجع نور الأمم، 34-35)، حتى يتمكنوا من تمييز طرق الإنجيل في الوقت الحاضر. إنّه ”حس“ الخراف، لكن لننتبه: إنّنا جميعًا في تاريخ الخلاص خراف أمام الراعي الذي هو الرّبّ يسوع. تساعدنا الصورة لنفهم البُعدين اللذين يساهمان في هذا ”الحس“. الأوّل شخصي والآخر جماعي: نحن خراف وجزء من القطيع، الذي يمثّل في هذه الحالة الكنيسة. نقرأ في كتاب صلاة الساعات، في صلاة القراءات، القراءة عن ”الرعاة“ لأغسطينس، حيث يقول: ”معكم أنا من الخراف، ولكم أنا راعٍ“. هذان الجانبان، الشخصي والكنسي، لا ينفصلان: لا يمكن أن يوجد حس إيمان بدون مشاركة في حياة الكنيسة، وهي ليست مجرد نشاطات كاثوليكيّة، بل يجب أن تكون قبل كلّ شيء ذلك ”الشعور“ "الذي هو أَيضًا في المَسيحِ يَسوع" (فيلبي 2، 5).
لا يمكن أن يقتصر حس الإيمان على التواصل والمقارنة بين الآراء التي قد نحملها تجاه هذه المسألة أو تلك، أو في هذا الوجه الخاص من العقيدة أو في قانون ما مِن قوانين الكنيسة. لا، هذه أدوات، إنّها تعابير لفظية، إنّها تعابير عقائدية أو تأديبية. ولا يمكن أن تسود فكرة التمييز بين الأكثريّة والأقليّة: هذا يحدث في البرلمان. كم مرة أصبح المهمّشون حجرًا للزاوية، (راجع مزمور 118، 22 ؛ متى 21، 42) والبعيدون صاروا قريبين. لقد تمَّ اختيار المهمشين والفقراء واليائسين ليكونوا سرًّا (أداة وعلامة) للمسيح (راجع متى 25، 31-46).
هكذا هي الكنيسة. وعندما أرادت بعض المجموعات أن تبرز أكثر من غيرها، كانت هذه المجموعات تلاقي دائمًا نهاية سيئة، حتى في إنكار الخلاص، وفي الهرطقات. لنفكر مثلًا في الهرطقات التي ادَّعت التقدّم بالكنيسة، مثل البيلاجية، ثم الجانسينية. كلّ هرطقة انتهت بشكلٍ سيء. الغنوصيّة والبيلاجيّة تجارب مستمرة في الكنيسة. نحن نهتمُّ بأن يُساهم كلّ شيء في الرفع من مستوى الاحتفالات الليتورجية، وهذا أمر جيد - حتى لو انتهى بنا الأمر في كثير من الأحيان إلى إرضاء أنفسنا فقط - لكن القديس يوحنا الذهبي الفم يحذرنا: "هل تريد أن تكرّم جسّد المسيح؟ لا تسمح بأن تكون أعضاؤه موضع احتقار، أي الفقراء الذين لا ثوب لهم يكسوهم. لا تكرمه هنا في الكنيسة بالأقمشة الحريريّة، بينما تتجاهله في الخارج عندما يعاني من البرد والعري. الشخص الذي قال: ”هذا هو جسدي“، مؤكدا الحقيقة بالكلمة، قال أيضًا ”كنت جائعًا فلم تُطْعمُونِي“. وكلّ مرة لم تفعلوا هذه الأشياء لواحد من هؤلاء الصغار، لم تفعلوه حتى لي" (عظة في إنجيل متى، 50, 3). ”لكن يا أبت، ماذا تقول؟ هل الفقراء والمتسولون والشباب مدمنو المخدرات، وكلّ هؤلاء الذين يتجاهلهم المجتمع جزء من السينودس؟“ نعم يا عزيزي، نعم يا عزيزتي: أنا لا أقول ذلك، قال ذلك الرّبّ يسوع: هم جزء من الكنيسة. لدرجة أنّك إذا لم تَدْعُهم، ولم تجد طريقة ما، أو إذا لم تذهب إليهم لتكون معهم لفترة من الوقت، لا لسماع ما يقولون ولكن لما يشعرون به، حتى الإهانات التي يوجهونها لك، فأنت لا تقوم بالسينودس بشكل جيد. السينودس يصل إلى الحدود، ويشمل الجميع. يفسح المجال للحوار في مآسينا، ومآسِيّ أنا أسقفكم، ومآسي الأساقفة المساعدين، ومآسي الكهنة والعلمانيين، والمنتمين إلى الجمعيات. السينودس يتكلّم على جميع هذه المآسي! وإذا لم نقم بإدراج بؤساء المجتمع- بين مزدوجين - والمستبعدين، لن نتمكن أبدًا من تحمل مسؤولية مآسينا. وهذا أمر مهم: لا مانع من أن نُظهِر مآسينا في الحوار، وبدون تبريرات. لا تخافوا!
من الضروري أن نشعر بأنّنا جزء من شعب واحد كبير، إليه وُجِّهَت الوعود الإلهية المُنفتحة على مستقبل ينتظر بأن يتمكن الجميع من أن يُشارك في الوليمة التي أعدّها الله لجميع الشعوب (راجع أشعياء 25، 6). وهنا أودّ أن أوضّح أيضًا مفهوم ”شعب الله“. يمكن أن توجد تأويلات متشددة ومتضاربة، تحاصرها فكرة التفرّد والامتيازات، كما حدث في تفسير مفهوم ”الاختيار“ الذي صححه الأنبياء، لكي يُفهَم فهمًا صحيحًا. ليس الأمر امتيازًا – أن نكون شعب الله - وإنّما هي عطية ينالها أحدٌ ما... من أجله؟ لا: إنّها من أجل الجميع، العطيةُ تؤخَذ لتُعطَى: هذه هي الدعوة. إنها عطية ينالها واحد من أجل الجميع، نلناها نحن من أجل الآخرين، فهي عطية وأيضًا مسؤولية. مسؤولية الشهادة بالأعمال وليس بالكلام فقط لعظائم الله، التي إن عُرفت ساعدت الناس على اكتشاف وجوده وقبول خلاصه. الاختيار عطية والسؤال هو: بكوني مسيحيًّا، ومذهبي مسيحيّ، كيف أعطيه، وكيف أمنحه؟ إرادة الله الخلاصية الشاملة دخلت التاريخ، من أجل البشرية جمعاء، من خلال تجسّد الابن، لكي يصبح الجميع، بوساطة الكنيسة، أبناءه وإخوة وأخوات في ما بينهم. بهذه الطريقة تتحقق المصالحة الشاملة بين الله والبشرية، ووَحدة الجنس البشري بأسره التي تشكّل الكنيسة علامة وأداة لها (راجع نور الأمم، 1). حتى قبل المجمع الفاتيكاني الثاني، نضج التفكير المفصّل في الدراسة المتأنية للآباء، بأنّ شعب الله يتجه نحو بلوغ الملكوت، ونحو وَحدة الجنس البشري الذي خلقه الله وأحبّه. والكنيسة كما نعرفها ونختبرها، في الخلافة الرسوليّة، يجب أن تشعر بأنّها مرتبطة بهذا الاختيار الشامل ولهذا السبب تحمل رسالتها. بهذه الرّوح كَتبت Fratelli tutti (كلّنا أخوة - رسالة بابويّة عامة). إنَّ الكنيسة، كما قال القديس بولس السادس، هي معلمة للبشريّة وهدفها اليوم أن تصبح مدرسة أخوَّة.
لماذا أقول لكم هذه الاشياء؟ لأنّه على الإصغاء في المسيرة السينودية، أن يأخذ بعين الاعتبار حسَّ الإيمان، لكن يجب ألّا يتجاهل كل تلك ”الهواجس“ التي تتجسّد حيث لا نتوقعها: قد يكون هناك ”حسّ من غرباء“، ولكن ليس أقل فعالية. إنّ الرّوح القدس في حريته لا يعرف حدودًا، ولا يسمح للانتماءات أن تقيِّده. وإذا كانت الرعية هي بيت الجميع في الحيّ، وليست ناديًا لأعضاء محدودين، فإنّني أوصيكم: اتركوا الأبواب والنوافذ مفتوحة، ولا تضعوا حدودًا حول أنفسكم فتأخذوا بعين الاعتبار فقط الأشخاص الذين يشاركون في الرعيّة أو يفكرون مثلكم - والذين قد يكونون ثلاثة أو أربعة أو خمسة بالمئة، لا أكثر. اسمحوا للجميع أن يدخل... واسمحوا لأنفسكم بالخروج للقائهم واسمحوا لهم بأن يسألوكم، فربما تكون أسئلتهم هي أسئلتكم، واسمحوا لهم بالسير معًا: سيقودكم الرّوح، ثقوا بالرّوح. لا تخافوا أن تدخلوا في حوار ودعوا أنفسكم تضطرب بسبب الحوار: إنّه حوار الخلاص.
لا تكونوا محبطين، واستعدّوا للمفاجآت. يوجد حادثة في سفر العدد (الفصل 22) تتكلّم على أتان ستصبح نبيّة لله. كان اليهود في نهاية الرحلة الطويلة التي ستقودهم إلى أرض الميعاد. وأخافَ مرورُهم بالاق ملكَ موآب الذي اعتمد على قدرات الساحر بلعام في صدّ هؤلاء الناس، على أمل تجنّب الحرب. سأل الساحر، المؤمن بطريقته، الله ماذا أفعل. قال الله له ألّا يرافق الملك، لكنّ هذا أصرّ، فاستسلم الساحر وركب الأتان لتنفيذ الأمر الذي تلقاه. لكن الأتان غيرت اتجاهها لأنّها رأت ملاكًا بسيف مسلول يقف هناك تعبيرًا عن معارضة الله. فشدَّها بلعام، وضربها، دون أن يتمكن من إعادتها إلى الطريق. حتى بدأت الأتان تتكلّم، فبدأ حوار فتح عيون الساحر، وحوّل رسالته من لعنة وموت إلى رسالة بركة وحياة.
تعلِّمُنا هذه القصة أن نثق بأنّ الرّوح سيجعل صوته مسموعًا دائمًا. حتى الأتان يمكن أن تصبح صوت الله، وتفتح أعيننا وتغيّر اتجاهاتنا الخاطئة. إذا كانت الأتان تستطيع أن تفعل ذلك، فكم بالأحرى المعمّد والمعمّدة والكاهن والأسقف والبابا. يكفي أن نثق بالرّوح القدس الذي يستخدم كلّ المخلوقات ليكلّمنا: يطلب منا فقط أن ننقِّي آذاننا لنسمع جيدًا.
جئت إلى هنا لأشجعكم لتأخذوا هذه المسيرة السينودية على محمل الجد ولكي أقول لكم إنّ الرّوح القدس يحتاج إليكم. وهذا صحيح: الرّوح القدس يحتاج إلينا. أصغوا إليه بإصغائكم بعضكم إلى بعض. لا تتركوا أحدًا خارجًا أو خلفكم. هذا الامر سيفيد أبرشية روما والكنيسة بأسرها التي لا تَقوَى فقط من خلال إصلاح هيكلياتها، - هذه هي خدعة كبيرة- وإعطاء التعليمات، وتقديم الرياضات الرّوحيّة والمؤتمرات، أو بفضل التوجيهات والبرامج، - هذا جيّد، لكنّه جزء من شيء آخر- تَقوَى الكنيسة إذا اكتشفت نفسها مجدّدًا أنّها شعب يريد أن يسير معًا، فيما بيننا ومع البشريّة. شعب روما الذي يشمل تنوع كلّ الشعوب وكلّ الحالات: يا له من غنى غير عادي، في تنوعه! لكن من الضروري أن نخرج من نسبة الثلاثة والأربعة بالمائة التي تمثّل الأشخاص القريبين، وأن نذهب إلى أبعد من ذلك للإصغاء إلى الآخرين، الذين قد يشتمونكم في بعض الأحيان، ويطردونكم، لكن من الضروري أن نسمع ما يفكرون فيه، دون أن نريد فرض أنفسنا وأفكارنا: لنترك الرّوح يكلِّمنا.
في زمن الجائحة هذه، الرّبّ يسوع يدفع رسالة الكنيسة لتكون سرًّا، أداة وعلامة، للعناية. لقد ارتفع صراخ العالم، وأظهر ضعفه: العالم بحاجة إلى من يعتني به.
تشجّعوا وإلى الأمام! شكرًا!
***********
© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2021
Copyright © دائرة الاتصالات